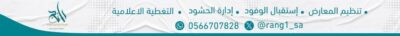حكاية !
مالتْ وقد سألتْ... مَن أنتَ؟ قلتُ أنا
طيفٌ تسربلَ همّاََ من هُنا وهنا
قالتْ وما ذاكَ قُلْ علّلْ بمفردةِِ
فقلتُ مفردتي غَنّتْكِ لحنَ مُنى
أُسامرُ الليلَ في نجواهُ يُرسِلُني
مُتيَّمَ القلبِ مشتاقاََ ومرتَهَنا
تجري بيَ الآهُ حرَّى في مدارِكِها
فأرتمي في لَظَاها أرقبُ الزَّمَنا
يغشانيَ الألمُ المنصَبُّ في شَغَفِِ
فما طعمتُ هدوءَ البالِ والوَسَنَا
تَتْييمُ قلبيَ كم أجريتُه أملاََ !
ينساقُ في الرُّوحِ كيما يُطْفِئَ الشّجَنا
جعلتُكِ النورَ في عيني وما ارتَسَمتْ
بقَلبِكِ الصورةُ العَطْشَى...فَزِدتُّ وَنَى
——
يدهشنا الأديب الكبير والشاعر الماهر الأستاد يحيى معيدي ببراعته في اختيار أسماء قصائده هذا فضلاً عن براعته الشعرية، وفي هذه القصيدة يبدو أن ( حكاية ! ) ليس اسماً أو عنواناً للقصيدة تم اختياره بعيد ولادتها، وقد اعتدنا أن يقتبس الشعراء أسماء وعناوين لنصوصهم من بين ألفاظ النص وعناصره وهذا ما يحدث غالباً، لكن اسم (حكاية! ) مع علامة التعجب كأنما ولد مع النص، إذ يبدو كما لو أنه جزءٌ لا يتجرأ من ذاك التفاعل الوجداني المنتج لهذا النص الفاخر، فجاء محيطاً بالنص إحاطةَ المشيمة بالجنين، ومثلما يستمد الجنين غذاءه من المشيمة أجد وكأنَّ النص يستمد مكوناته الفنية والخبرية من العنوان، فثمة حكايةٌ تُروى، والحكاية دائماً تولد مع اسمها في آن.
فالقصيدة حكاية، والحكاية هي تلك التجربة المولِّدة للقصيدة.
والتجربة لا تكون حكاية ما لم تكن موغلة في خط الزمن، ومثيرة للعجب، ومفعمة بالإثارة والدهشة...
وعلى الرغم من أنَّ الشاعر لم يذكر تاريخ النص، فقد يكون قديماً وقد يكون جديداً، غير أن التجربة ذاتها لا بدَّ وأنها ذات امتداد زمني بعيد، تداعت إلى الحاضر في لحظة تذكر مجيدة، أو لقاء قدري عابر في الواقع الحي ،أو في خيال الشاعر المتيّم ، ويتجسد هذا الفهم من خلال ذلك الاستفهام المتوشح بمشاعر الإنكار القاسي على لسان محبوبته حين يقول:
مالتْ وقد سألت من أنت؟ قلت أنا
طيفٌ تسربل هماً من هنا وهنا.
وهنا تتجلى براعة الشاعر في وصف المشهد بكل ما فيه من أسىً وألم، فليس أوجع من أن ينكر الحبيب محبوبه، وينسى ملامحه وذكراه، وكأنَّ الشاعر(ناجي) يطلُّ بأطلاله ومأساته، ليشهد تلك اللحظة العارمة حين يقول:
يا حبيبي كل شيء بقضاء
ما بأيدينا خلقنا تعساء
ربما تجمعنا أقدارنا
ذات يوم بعد ما عز اللقاء
فإذا أنكر خلٌّ خله
وتلاقينا لقاء الغرباء
ومضى كلٌّ إلى غايته
لا تقل شئنا فإنَّ الحظ شاء.
ومثلما لناجي وأطلاله حكاية تُروى وتُغنّى، فللمعيدي وحكايته أطلال
لم تندثر، وطيف تسربل بالهموم ، وذكريات لم تنسَ ،وجرح نازف لم يلتئم، وآهات حرّى ، وانتظار طويل، وشوق مرير، ورغبات عطشى، وصدود محبوب رغب عن فهم حال عاشقه، بعد أن غنّاه لحن المنى، وعزف على أسماعه معزوفة العاشقين .
أُسامرُ الليلَ في نجواهُ يُرسِلُني
مُتيَّمَ القلبِ مشتاقاََ ومرتَهَنا
تجري بيَ الآهُ حرَّى في مدارِكِها
فأرتمي في لَظَاها أرقبُ الزَّمَنا
يغشانيَ الألمُ المنصَبُّ في شَغَفِِ
فما طعمتُ هدوءَ البالِ والوَسَنَا
فما زال الشاعر يعاني، وما انفكَّ يبكي أطلاله وذكرياته، ويرويها حكاية مدموغة بعلامة تعجب دامية...
هذا النص الرائع يجسد التفاتةً إلى الوراء بحسرة تنبثق عنها متعةٌ مثيرة للحواس، وقد أجاد الشاعر إعادة خلْق الماضي ،وإحياءَ الحلم الشفّاف في إهابٍ ممشوق من الجمل والمفردات، بلغة راقية مكللة بالعفّة والوقار، ومفعمة بقوة الأحاسيس والمشاعر، وعذابات التجربة، وتداعيات الهموم والأمنيات، وليس أشد وطأة على النفس من أن تكون تحت رحمة ذكريات الصدود والنسيان والحرمان...
تَتْييمُ قلبيَ كم أجريتُه أملاََ !
ينساقُ في الرُّوحِ كيما يُطْفِئَ الشّجَنا
جعلتُكِ النورَ في عيني وما ارتَسَمتْ
بقَلبِكِ الصورةُ العَطْشَى...فَزِدتُّ وَنَى
… لكن عزاؤنا أنه ليس كالذاكرة ما ينشط الرغبة في الحياة، ويحيي الأمل في الصدور، ( غير أن الذاكرة للأديب سيرينة حقيقية كما يقول جبرا إبراهيم جبرا ) …
والسرينة هي حوريّة البحر تلك المخلوقة الأسطورية الحسناء التي تغوي البحارة بغنائها الساحر، فيقصدون شاطئها الصخري، حيث تتحطم مراكبهم فتلتهمهم السرينات ، أو يهبن لهم الخلود بدموعهن السحرية ، وهكذا سمي شاطئ السرينات المكتظ بعظام القتلى وبقايا المراكب باسمهن ..
ولكن ماذا بوسع الشاعر أن يفعل،
إذا لم يسمح لنفسه بأن تغويه الذاكرة، ويستدرجه الحلم، وتقتله الرغبة، وتلتهمه تلك الأنثى التي لا تُقاوم ؟!
لعل وعسى أن يولد من جديد.!
وذلك هو أصل الحكاية .!






 (
( (
(